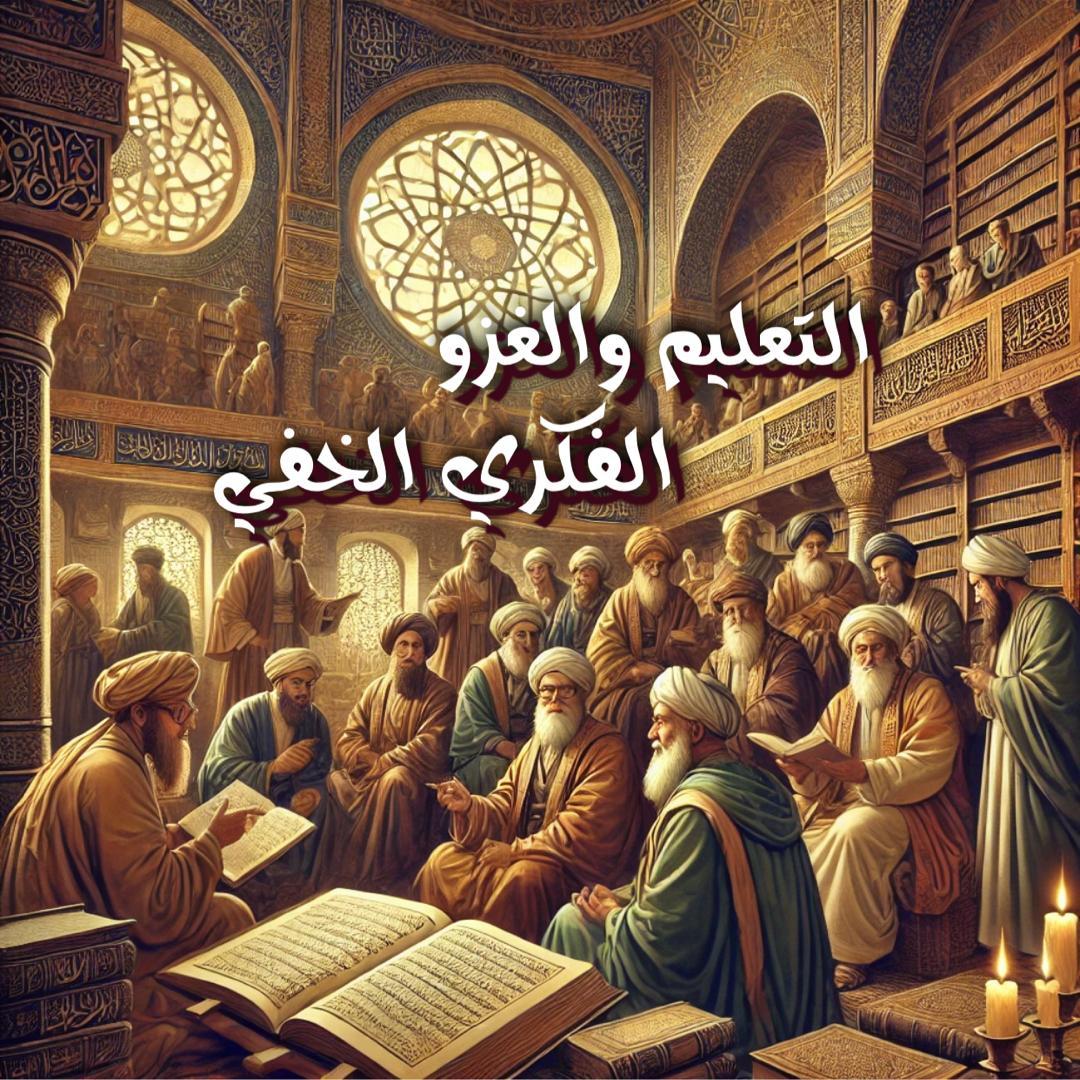
التعليم والغزو الفكري الخفي
كيف تم برمجة عقول الأفراد منذ الطفولة للانشغال بقضاياهم الشخصية على حساب قضايا الأمة
في خضم الحياة المعاصرة، نجد أنفسنا محاطين بأفكار وعادات ترسخت في عقولنا منذ الطفولة دون أن نراجع أصولها أو مدى تأثيرها على واقعنا. كثير من المفاهيم التي نعتبرها بديهية أو مسلّمة ليست سوى أدوات تم استخدامها بذكاء لإبعادنا عن أدوارنا الحقيقية في بناء أمتنا، وتشكيل وعينا بطريقة تخدم مصالح قوى خارجية لا تريد لنا النهوض.
سنتناول في هذا المقال ثلاث أفكار رئيسية تم زرعها في أذهاننا، وهي:
- الانشغال ببناء المستقبل الشخصي
- تقديس الوطنية بمعناها الضيق
- الصبر السلبي الذي يقتل روح المقاومة والتغيير
سنناقش جذور هذه الأفكار، ونبيّن كيف أنها ساهمت في إضعاف الأمة، ثم نقدم تصورًا لكيفية تجاوزها واستعادة وعينا الحقيقي.
أولًا: بناء المستقبل الشخصي – فخ التعليم والعمل
التعليم: رحلة طويلة ذات فائدة محدودة
نشأنا جميعًا على فكرة أن الحياة تدور حول بناء مستقبلنا الشخصي، وأن النجاح يتمثل في الحصول على شهادة دراسية مرموقة ثم وظيفة ذات راتب جيد. لكن عند التدقيق في هذا المفهوم، نجد أنه ليس بريئًا كما يبدو، بل هو وسيلة لإبقاء الشباب منشغلين بأنفسهم، بعيدين عن قضايا أمتهم المصيرية.
نظام التعليم الحديث صُمِّم ليُبقي الإنسان في دوامة طويلة من الدراسة، تمتد لعشرين عامًا أو أكثر، في حين أن علماء المسلمين في العصور الذهبية لم يكونوا بحاجة إلى هذا الكم الهائل من السنوات ليصبحوا علماء ومؤثرين في مجتمعاتهم. كانت عملية التعلم عندهم ترتكز على الفهم العميق والتطبيق العملي، وليس مجرد اجتياز الاختبارات والحصول على الشهادات.
أما اليوم، فأصبح التعليم هدفه الأساسي تأهيل الطلاب لسوق العمل، وليس لصناعة قادة ومفكرين وعلماء قادرين على إحداث تغيير حقيقي. والنتيجة؟ شباب يقضون أجمل سنوات عمرهم في التعليم ثم يجدون أنفسهم في وظائف برواتب لا تكفي لسد احتياجاتهم الأساسية، ما يجعلهم مستمرين في دوامة البحث عن الاستقرار المادي، غافلين عن قضايا أمتهم.
لماذا يُشغلون الشباب بمستقبلهم الشخصي؟
عندما يُطرح أي موضوع مصيري – كالقضية الفلسطينية مثلًا – نجد كثيرًا من الشباب يردون بعبارات مثل: "أنا لا أزال طالبًا، عليّ بناء مستقبلي أولًا"، أو "أتمنى أن أنصر القضية، لكنني مشغول بدراستي ووظيفتي". هذه العقلية لم تأتِ من فراغ، بل هي نتيجة برمجة طويلة المدى تهدف إلى إبقاء الجيل الصاعد بعيدًا عن تحمل المسؤولية الكبرى.
لو قارنا ذلك بتاريخ الأمة الإسلامية، لوجدنا أن الشباب كانوا في طليعة القادة والمجاهدين والعلماء، وأنهم لم يكونوا بحاجة إلى شهادة جامعية ليُحدثوا فرقًا في العالم. اليوم، أصبحنا نؤجل كل شيء حتى نجد أنفسنا في عمر متقدم دون أن نقدم شيئًا حقيقيًا لأمتنا.
ثانيًا: الوطنية الضيقة – عندما يصبح الوطن حاجزًا بدلاً من حافز
الوطنية الحقيقية مقابل الوطنية المزيفة
الإسلام لم يحدد مفهوم الانتماء بالحدود الجغرافية، بل جعل الأمة الإسلامية وحدة واحدة، حيث يقول النبي ﷺ: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد". لكن اليوم، أصبحنا نرى أن حب الوطن يعني الاكتفاء بالدفاع عنه فقط، دون الاهتمام بقضايا المسلمين في بقية أنحاء العالم.
يتم زرع فكرة أن لكل دولة سيادتها الخاصة، وأن التدخل في شؤون الدول الأخرى مرفوض، حتى لو كانت هذه الدولة تُباد أمام أعيننا كما يحدث في فلسطين. أصبحنا نقول: "هذه مشكلتهم، ونحن لدينا مشاكلنا", رغم أن الإسلام لم يضع هذه الحواجز.
كيف أثرت هذه الفكرة على واقعنا؟
عندما تشتعل الأزمات في أي بلد إسلامي، نجد أن الشعوب الأخرى لا تتحرك إلا بالكاد، لأن عقولهم مبرمجة على أن هذه ليست معركتهم. لو أن المسلمين في الدول المجاورة لفلسطين، أو حتى البعيدة عنها، تحركوا بنسبة 5% فقط ضد الاحتلال، لما استمرت الجرائم بحق أهل غزة.
لكن الوطنية بالمفهوم الحديث جعلتنا نرضى بأن نكون مجرد متفرجين، نكتفي بالدعاء أو التبرعات المحدودة، دون اتخاذ خطوات فعلية للتأثير في مجريات الأمور.
ثالثًا: الصبر السلبي – كيف تم استغلاله لإخماد المقاومة؟
الفرق بين الصبر الفعّال والصبر السلبي
الصبر قيمة عظيمة في الإسلام، لكنه ليس صبرًا على الظلم، بل صبرٌ على تحمل المشقة في سبيل نصرة الحق. ومع ذلك، تم التلاعب بهذا المفهوم حتى أصبحنا نعتقد أن الصبر يعني القبول بالظلم وعدم مواجهته.
قال الله تعالى: "وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر". أي أن الصبر يجب أن يكون مقرونًا بإظهار الحق وعدم السكوت عن الظلم. لكن في واقعنا، يتم تعليم الناس أن الصبر يعني التعايش مع الظلم وانتظار الفرج دون أي محاولة للتغيير.
كيف يخدم الصبر السلبي الظالمين؟
الحكام المستبدون استفادوا من هذا المفهوم، حيث رسّخوا فكرة أن أي اعتراض على سياساتهم هو خروج على ولي الأمر، وأن المظلوم يجب أن يتحمل الظلم بصمت. ونتيجة لذلك، أصبح الناس يخافون من المطالبة بحقوقهم، ويعتقدون أن السكوت هو الحل الوحيد لتجنب الفتن.
لكن الحقيقة هي أنه كلما صمت الناس على الظلم، زادت كلفة إزالته لاحقًا. فلو تم التصدي لأول مظلمة بقوة، لما احتاجت الشعوب لاحقًا إلى الثورات العنيفة لإسقاط الطغاة. في الدول الغربية، يُدرَّس للناس أن تجاهل الظلم الصغير يؤدي إلى كارثة، لأن الظالم لن يتوقف عند حد معين بل سيتمادى ما دام لا يوجد من يردعه.
الخاتمة: كيف نكسر هذه القيود؟
لحل هذه المعضلة، يجب أن نعيد بناء وعينا على أسس صحيحة، عبر:
- إعادة النظر في مفهوم التعليم والعمل – علينا أن نربي أبناءنا على أن الهدف من التعلم هو امتلاك أدوات التغيير، وليس مجرد الحصول على شهادة ووظيفة.
- إعادة تعريف الوطنية – لا ينبغي أن تكون حدود الدول عائقًا أمام نصرة الحق، بل يجب أن يكون الانتماء الأول للدين، وليس لقطعة أرض مرسومة على الخريطة.
- إعادة فهم الصبر – يجب أن يكون صبرًا إيجابيًا، مقرونًا بالمطالبة بالحق والتصدي للظلم من بدايته.
تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية – في مجتمعاتنا، أصبح التفكير الفردي هو السائد، حيث يسعى معظم الناس لتحقيق مصالحهم الشخصية دون النظر إلى تأثير ذلك على المصلحة العامة. أما في دول أخرى مثل الصين، لا يمكن للفرد أن يشتري سيارة تستهلك البترول بشكل كبير حتى وإن كان قادرًا ماديًا، لأنه يرى أن ذلك سيؤثر سلبًا على اقتصاد البلاد. كما أن العمال هناك لا يأخذون إجازات إلا عند الضرورة، لأنهم يعتبرون أن غيابهم سيؤثر على زملائهم وسير العمل.
هذا النموذج يعكس كيف أن تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية يمكن أن يؤدي إلى ازدهار الأمم. أما في مجتمعاتنا، فالكثيرون لا يبالون إن كانت تصرفاتهم تضر بالمجتمع، طالما أنها تحقق لهم مكاسب فردية.
إذا استطعنا التخلص من هذه الأغلال الفكرية، سنرى أمةً أكثر وعيًا، أقوى تأثيرًا، وأقرب إلى تحقيق نهضتها الحقيقية.
Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *



